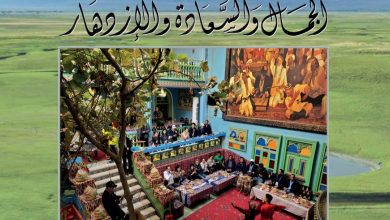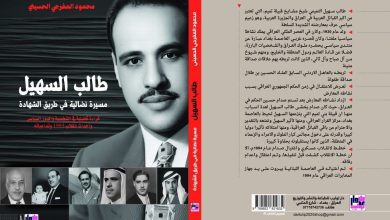عودٌ في الربع الخالي

اجنادين نيوز / ANN
قصة قصيرة حقيقية
ليث عبد الغني
في صحراء لا تُشبه سوى نفسها، تمتد رمالها كأبدٍ أصفر لا ينتهي، كُنّا مجرد ظلال بشرية نرتدي بجامات متشابهة، نقيم تحت طرگة خيمة لا ترد عنّا حر الشمس ولا جنون الريح. لا شيء حولنا سوى صمتٍ مطبِق وعقارب تتسلل إلى أحلامنا قبل أقدامنا. ومع ذلك، ووسط هذا العدم، وُلدت حركة فنية… نعم، فنية.
بدأ الأمر عشوائياً، عندما لطخ أحدهم كرتونة فارغة من علب الماء بخطوط من معجون الطماطم والكركم، وضحك قائلاً: “هذا غروب شمس على جرف الهور”. ضحكنا، لكن اللوحة بقيت معلقة على وتد الخيمة كأنها ترفض الاختفاء. تبعتها لوحات أخرى: معجون الأسنان أصبح أبيضاً ناصعاً يرسم قمم الجبال، وشرائح الباذنجان المهترئة صنعت سحباً رمادية فوق أفق لا نراه.
أبو عقرب، كما سميناه، لم يرسم. بل نحت عقرباً من إسفنجة فراشه، ربطها بخيط من سرواله البالي، وعلّقها على مقدّمة خيمته، علامة تحذير، أو ربما صرخة احتجاج على كثرة الزواحف التي تشاركنا المحتجز.
لكن أكثرنا مثابرة كان ماجد أبو الليل. رجل هادئ، صبور كخشب الزيتون. لم يكن موسيقياً ولا يتقن العزف، لكنه كان نجاراً يعرف كيف يُنطق الخشب. حين وقف في منتصف الساحة، قال بابتسامة خجولة:
“أنا لا أعزف… لكني استطيع ان أصنع.”
ثم أردف بتواضع:
“بالمناسبة، قبلي حاولوا اثنين… جمال ونوري، وأنا كنت الثالث. لكن حاولت أضيف شي.”
جمال كان أول من خطر بباله أن يجعل من عصا المكنسة زنداً، ومن علبة معجون الطماطم صندوق طنين. ونوري جرّب استخدام أسلاك المعجون كأوتار، لكنهما افتقرا إلى الصبر أو إلى الأدوات. أما ماجد، فجمع أغطية العلب المعدنية، وصفيحة صدئة كانت لصندوق زيتون، سكب ما بقي فيها من زيتها على الرمل، ومسحها بقطعة من ملابسه، وقال:
“ستكون هذه العلبة صوت.”
وبصبر العارفين، حفر الخشب، ولصق الأجزاء، وفتل الأوتار من خيوط مهملة. لم يكن عزف العود الأول له، بل أهداه لفنان من الزبير يُدعى سيد مجتبى، كان صوته يملأ الخيمة في الليل كأن المدينة عادت إلينا من خلاله.
لاحقاً، بعد أن توفّرت أدوات أفضل، صنع ماجد أعواداً أجمل، أدق، أشد نقاء. لكنه ظل يقول:
“أجمل عود؟ هو الأول. لأننا صنعناه في مكان لا يُفترض أن يولد فيه شيء.”
في تلك الليالي، كنّا نغلق أعيننا ونصغي. لم نكن نسمع موسيقى فقط، بل كنا نسمع البصرة وهي تنهض من سباتها، وصوت شط العرب وهو يشقّ ليل المحتجز بأمواجه، كأنّها رسائل من المدينة إلى ابنها المنفي في الرمل.
ذات فجر، عزف سيد مجتبى لحناً لم نسمعه من قبل. لم يكن مقاماً معروفاً، ولا أغنية متداولة. كان شيئاً يشبه الدعاء، يشبه البكاء، يشبه ابتسامة من فقد كل شيء إلا صوته. وعندما انتهى، نظر ماجد إلى العود وقال:
“إذا مت هنا، ادفنوه معي.”
لكن ماجد محمد عبدالله الحيدر لم يمت.
ذات مساء، فُتح له باب الصحراء بهدوء بعد عدة سنوات، وخرج. بلا ضجيج، بلا وداع. كأنّ الحياة تذكّرته أخيراً، ومنحته فرصة أخرى لصنع عود في فضاء أوسع من الخيمة.
خرج من ذلك المكان كما يخرج طائر من قفص لا يرى… ومن يومها، راح يصنع الأعواد كما يصنع الناجون الحكايات: من الخشب، والذاكرة، والبقاء. لا أحد كان يصدّق أن أول عود صنعه كان من صفيحة زيتون وأوتار ممزقة في صحراء منسية.
واليوم، في معارض الذاكرة،
تتجمّع الصور كأشباح في ضوءٍ باهت،
تسند جدراناً منسيةً في متحفٍ لم يزره أحد.
وهناك، في الركن المعتم، تتشكّل صور آلته…
تلك التي صنعها من جوف الموت،
بمسامير جمعها من بقايا خشب البال،
وبصفائح اقتطعها من نفايات المحتجز،
ومن أنفاس محجوزين قسراً ماتوا دون أن يقولوا وداعاً.
لم تكن آلةً موسيقية،
ولا أداة غربة…
بل آلة ذاكرة،
يدير بها عجلة الزمن،
ليعيد وجوه رفاق الدرب،
ويوقظ أسماءهم من الرمال الكثيفة.
قال ماجد يوما ما:
“اعرف اني لا أعزف، لكن الخيمة احتاجت صوتاً.”
لأن الإنسان المبدع، حين يشتعل خياله، لا توقفه الصحراء، ولا تمنعه الخيام المتهرئة، ولا تحاصره الأسلاك.
المبدع لا يعرف الحدود…
هو يخلق الحياة من العدم، والنور من خشب نطق، والحرية من وترٍ يرتجف في قلب الريح.